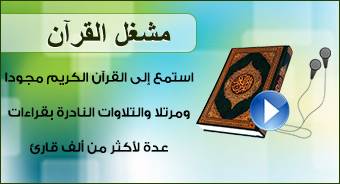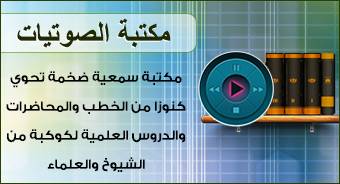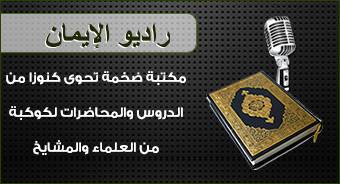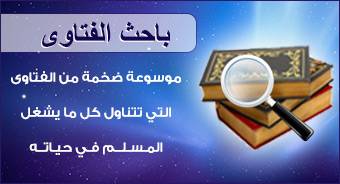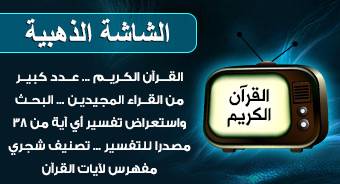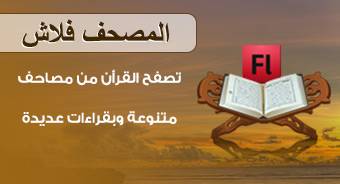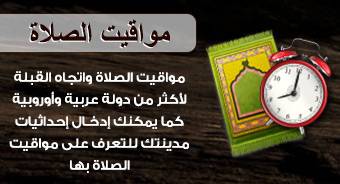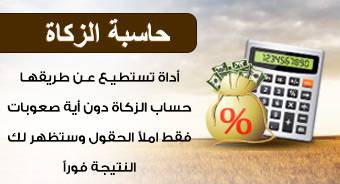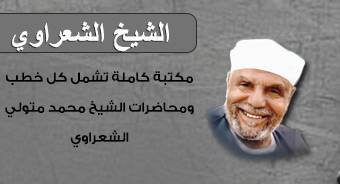|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن **
حذف نون الرفع له خمس حالات ثلاث منها يجب فيها حذفها وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتها وواحدة يقصر فيها حذفها على السماع، أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على الفعل عامل جزم والثانية إذا دخل عليه عامل نصب والثالثة إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية لكون المفعول ياء المتكلم فيجوز الحذف والإثبات ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية {فَبِمَ تُبَشِّرُونَ} بالكسر وكذلك قوله تعالى:
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله:
لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار
فهو نادر حملًا للم على أختها لا النافية أو ما النافية وقيل هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل وكذلك بقاء النون مع حرف النصب في قوله: أن تقرأن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في عدم النصب بها كما أشار له في الخلاصة بقوله: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا
ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم:
قوله تعالى:
تنبيه
في هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله:
* وحكمها في القصد حكم الأول *
ليس صحيحًا على إطلاقه. وأوضح مسألة تعدد الاستثناء بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلًا للأول
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا
وحيثما استغرق الأول قط فألغ واعتبر بخلف في النمط
قوله تعالى:
قوله تعالى:
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر
وقال الآخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم
هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد. فعن قتادة للمتوسمين أي المعتبرين، وعن مجاهد للمتوسمين أي المتفرسين، وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أي للناظرين، وعن مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين أي للمتأملين.
ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد، وكذلك قول ابن زيد ومقاتل للمتوسمين أي للمتفكرين، وقول أبي عبيدة للمتوسمين أي للمبتصرين، فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل وإطلاق التوسم على التأمل والنظر، والاعتبار مشهور في كلام العرب ومنه قول زهير: وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم
أي المتأمل في ذلك الحسن، وقول طريق بن تميم العنبري: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم
أي ينظر ويتأمل. وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ} قال: للناظرين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: {لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ}: قال للمعتبرين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ} قال: هم المتفرسون. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله:
قرأ نافع وابن عامر وابن كثير "ليكة". في "الشعراء" و "ص" بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي "الأيكة" بالتعريف والهمز وكسر التاء، وقرأ كذلك جميع القراء في "ق" و "الحجر". قال أبو عبيدة: ليكة والأيكة اسم مدينتهم كمكة وبكة، والأيكة في لغة العرب الغيضة وهي جماعة الشجر والجمع الأيك، وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض، ويروى أن شجرهم كان دومًا وهو المقل، ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة: تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردًا أسف لثانه بالإثمد
وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة، ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية، ويقال: هما مثل بكة ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة، والأيك هو الشجر الملتف.
قوله تعالى:
الحجر: منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة:
وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم:
فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدًا منهم فقد كذب جميعهم. ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقًا. قال:
وقد بينا هذه المسألة في كتابنا "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب".
تنبيه
اعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة تبوك، فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لمَّا مرَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تدخلوا مسكان الَّذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلاَّ أن تكونوا باكين ثمَّ قنَّع رأسه وأسرع السَّير حتَّى أجاز الوادي". وهذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا نزل الحجر في غزوة تبوك، "أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا قد عجنَّا منها واستقينا، فأمرهم أَن يطرحوا ذلك العجين ويهرقو ذلك الماء". ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم "أمر بإلقاء الطَّعام" ثم قال: وقال أبو ذر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "من اعتجن بمائه".
ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره: أَنَّ النَّاس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يهرقوا ما استقوا من بيارهم وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي تردها النَّاقة" ثم قال: تابعه أسامة عن نافع. ثم ساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا مر بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أَن يصيبكم ما أصابهم. ثمَّ تقنَّع بردائه وهو على الرَّحل".
ثم ساق أيضًا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابكم" هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. وقال ابن حجر في الفتح: أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة ـ الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحجر: "من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه" وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع. وأما حديث أبي الشموس ـ وهو بمعجمة ثم مهملة، وهو بكري لا يعرف اسمه ـ فوصله البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ـ فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينة وذو الحيس حيسه" ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد: "فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حست حيسة فألقمها راحلتي قال نعم".
وقال ابن حجر أيضًا: قوله وقال أبو ذر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم "من اعتجن بمائه" وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: "أنهم كانوا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فآتوا على واد فقال لهم النَّبي صلى الله عليه وسلم "إنكم بواد ملعون فأسرعوا" وقال: "من اعتجن عجينة أو طبخ قدرًا فليكبها" الحديث ـ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى
"لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم" وبعض هذه الروايات الذي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه، فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز ديارهم. وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها، وعدم أكل الطعام الذي عجن بها، ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. قال البخاري في صحيحه "باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب" ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المُحِل ـ وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام ـ قال "كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه أي تعداه" ومن طريق أخرى عن علي قال: "ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار" والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف لأنه ليس فيها إلا خسف
واحد. وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلاثًا. ورواه أبو داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: "نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة" في إسناده ضعف واللائق بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله:
وقول الخطابي ـ يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه، ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: "وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا" وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر أن فيه ضعفًا هو قوله: "حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر. فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ منها قال: "إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة".
حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: "فلما خرج" مكان "فلما برز" اهـ وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة القبول، ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقته الأولى أول طبقاتها سليمان بن داود ولا خلاف في كونه ثقة، وفي الثانية أحمد بن صالح مكان سليمان المذكور، وأحمد بن صالح ثقة حافظ. وكلام النسائي فيه غلط مردود عليه كما قال العراقي في ألفيته: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح
وسبب غلطه في ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح الشموني. فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري وليس كذلك كما جزم به ابن حبان.
والطبقة الثانية في كلا الإسنادين:
ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد مشهور.
والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر وعبد الله بن لهيعة ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق، وعبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن وهب ومعلوم أن رواية ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من رواية غيرهما عنه.
والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. وفي الإسناد الثاني الحجاج بن شداد وعمار بن سعد المرادي ثم السلهمي والحجاج بن شداد الصنعاني نزيل مصر كلاهما مقبول كما قاله ابن حجر في التقريب، واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن.
والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري وهو سعيد بن عبد الرحمن وعداده في أهل مصر، وهو ثقة.
والطبقة السادسة في كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فالذي يظهر صلاحية الحديث للاحتجاج ولكنه فيه علة خفية ذكرها ابن يونس، وهي أن رواية أبي صالح الغفاري عن علي مرسلة كما ذكره ابن حجر في التقريب. وقال البيهقي في السنن الكبرى "باب من كره الصلاة في موضع الخسف والعذاب" أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود، ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنفًا بلفظه في المتن والإسنادين. ثم قال: وروينا عن عبد الله بن أبي محل العمري قال: كنا مع علي بن أبي طالب فمر بنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه" وعن حجر الحضرمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرات". ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعًا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة. فلو صلى فيها لم يعد ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا عن البخاري ومسلم ثم قال: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم أحب الخروج من تلك المساكن، وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها. اهـ.
وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف والتطهر بمياهها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزىء واستدلوا بعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض كلها مسجدًا" الحديث. وكعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها واستدلوا بحديث على المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم "نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة" قالوا: والنهي يقتضي الفساد لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة. فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منه كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًا، وأنه لا يدخل إلا باكيًا للحديث الصحيح. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة والعلم عند الله تعالى.
مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله:
فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها ونبين، ما صح فيه النهي وما لم يصح.
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعًا ستأتي كلها عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله" رواه عبد بن حميد في مسنده والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي في إسناده: ليس بذاك. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة. لأن الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة وهو متروك، قال فيه ابن حجر في التقريب متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال ابن معين هو لا شيء. وقال البخاري منكر الحديث. وقال في موضع آخر متروك الحديث. وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًا، متروك الحديث لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. قلت وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًا، يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. وقال الفسوي ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي متروك وقال ابن حبان يروى المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته وقال الحاكم روى عن أبيه وداود بن الحصين وغيرهما المناكير وقال الدارقطني ضعيف. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف اهـ كلام ابن حجر. وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط، وفيه ابن عمر العُمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له مسلم. وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ـ يعني الحديثين ـ واهيان. وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين.
اعلم أولًا أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي السبعة المذكورة، والصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب وفي المكان المغصوب والصلاة إلى النائم والمتحدث وفي بطن الوادي وفي مسجد الضرار والصلاة إلى التنور، فالمجموع تسعة عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا.
وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا. وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعض الروايات. المتفق عليها "لعن الله اليهود والنصارى" وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنَّبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، رواه النسائي أيضًا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث "ولا تتخذوها قبورًا" دليل على أن القبور ليست محل صلاة وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم فإنهم لا يصلون. وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد" ورواه ابن أبي حاتم أيضًا.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة. لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد، لأن المسجد في اللغة مكان السجود، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "وجعلت لي الأرض مسجدًا" الحديث أي كل مكان منها تجوز الصلاة فيه. وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش. لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقوله الشافعية، بدليل اللعن الوارد من النَّبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة فالعلة للنهي سد الذريعة لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًا وهو مذهب الإمام أحمد وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة، وإن كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة: وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًا، وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة.
|